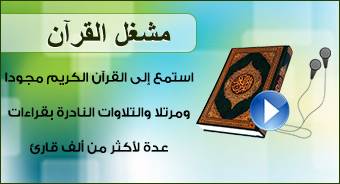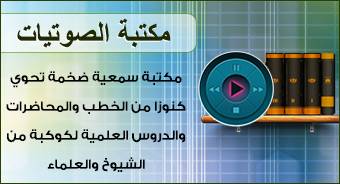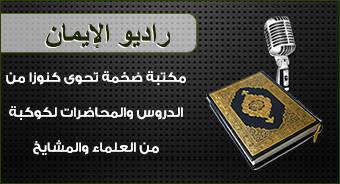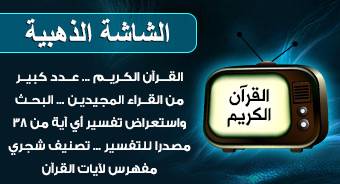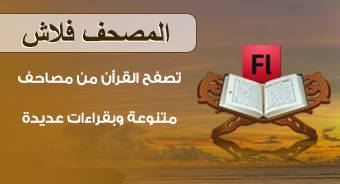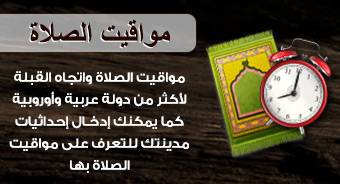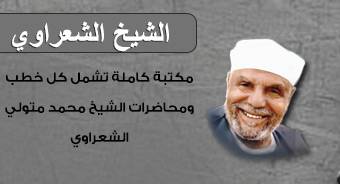|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم مقاييس اللغة ***
(عفق) العين والفاء والقاف أصل صحيح، يدلُّ على مجيءٍ وذَهاب، وربما يدلُّ على صوت من الأصوات. قال الخليل: عفَق الرّجُل يَعْفِق عَفْقاً، إذا ركب رأسَه فمضَى. تقول: لا يزال يعفِق العفقةَ ثم يرجع، أي يغيب الغَيبة. والإبل تَعفِق عَفْقاً وعُفُوقاً، إذا أُرْسِلَتْ في مراعيها فَمرّت على وجوها. وربما عفَقَتْ عن المرعى إلى الماء، ترجع إليه بين كلِّ يومين. وكلُّ واردٍ وصادرٍ عافقٌ؛ وكلُّ راجع مختلفٍ عافِق. وقال ابنُ الأعرابيّ في قوله: * حتَّى تَرَدَّى أربعٌ في المنعَفَقْ * قال: أراد في المنُصَرَف عن الماء. قال: ويقال: عفَق بنو فلانٍ [بني فلانٍ]، أي رجَعوا إليهم. وأنشد: * عَفْقاً ومن يرعى الحُمُوضَ يعْفِقِ * والمعنى أنّ من يرعى الحموض تَعَطشُ ماشيتُه سريعاً فلا يجدُ بُدَّاً من أن يَعْفِق، أي يرجعَ بسُرعة. ومن الباب: عَفَقَه عن حاجته، أي ردَّه وصَرَفه عنها. ومنه التعفُّق، وهو التصرُّف والأخْذ في كلِّ وجهٍ مشياً لا يستقيم، كالحيّة. قال أبو عمرو: العَفْق: سرعة رَجع أيدي الإبل وأرجلِها. قال: * يَعْفِقْنَ بالأرجل عَفْقاً صُلْبا * قال أبو عمرو: وهو يعفِّق الغنم، أي يردُّها عن وجوهها. ورجلٌ مِعفاق الزِّيارة لا يزال يجيء ويذهب. ويذكر عن بعض العرب أنّه قال: "انتلي فيها تأويلات ثم أعْفِق"، أي أقضي بقايا من حوائجي ثم أنصرف. قال ابن الأعرابيّ: تَعَفَّقَ بالشيء، إذا رجع إليه مرّةً بعد أخرى. وأنشد: تَعفَّقَ بالأرظَى لها وأرادَها ***رجالٌ فبذَّتْ نبلَها وكليبُ ومن الباب: قولهم للحَلَب عِفاق. وتلخيصُ هذا الكلام أنْ يحلبَها كلَّ ساعة. يقال عَفَقْتَ ناقتَك يومَك أجمعَ في الحَلَب. وقال ذو الخِرَق: عليك الشاءَ شاءَ بني تميمٍ *** فعافِقْهُ فإِنّك ذُو عِفاقِ ومن الباب: عفَقت الرِّيحُ التُّرابَ، إذا ضربَتْه وفَرّقته. قال سُويد: وإن تك نارٌ فهي نار بملتقَىً *** من الرِّيح تَمْرِيها وتَعْفِقها عَفْقا وأمّا الذي ذكرناه من الصَّوت فيقولون: عَفَق بها، إذا أنبقَ بها وحَصَم. ومما يقرُب من هذا الباب العَفْق ضربٌ بالعصا، والضِّرابُ، وكأنَّ ذلك تَصْوِيت. (عفك) العين والفاء والكاف أصل صحيح، وهو لا يدلُّ إلاّ على صفةٍ مكروهة. قال الخليل: الأعْفَك: الأحمق. قال: صاحِ ألم تعَجبْ لذاك الضَّيْطَرِ *** الأعْفَكِ الأخرَقِ ثمّ الأعسَرِ الضيطر: الأحمق الفاحش، والأعفك أيضاً والأخرق: الذي لا خيرَ فيه ولا يُحسِنُ عَملاً، وهو المخلَّع من الرِّجال. قال ابن دريد: "بنو تميمٍ يسمُّون الأعسَر الأعفَك". (عفل) العين والفاء واللام كلمة تدلُّ على زيادةٍ في خلقة. قال الخليل: العَفَل يخرج في حياء النّاقة كالأُدرة، وهي عَفْلاء. ويقال: العَفْل شحمُ خُصْيَي الكَبْش. قال بشر: * وارمُ العَفْل مُعْبَرُ * قال الكسائيّ: العَفْل: الموضع الذي يُجَسُّ من الشاة إذا أرادوا أن يعرفوا سِمَنها. (عفن) العين والفاء والنون كلمة تدلُّ على فسادٍ في شيء من نَدَى. وهو عَفِن الشَّيءُ يعفَن عَفَناً. (عفو) العين والفاء والحرف المعتلّ أصلان يدلُّ أحدهما على تركِ الشيء، والآخر على طَلَبِه. ثم يرجع إليه فروعٌ كثيرة لا تتفاوَتُ في المعنى. فالأوّل: العَفْو: عَفْو الله تعالى عن خَلْقه، وذلك تركُه إيّاهم فلا يعاقبُهم، فَضْلاً منه. قال الخليل: وكلُّ مَن استحقَّ عُقوبةً فتركْتَه فقد عفوتَ عنه. يقال عفا عنه يعفُو عَفْواً. وهذا الذي قاله الخليل صحيح، وقد يكون أن يعفُوَ الإنسان عن الشَّيء بمعنى الترك، ولا يكون ذلك عن استحقاق. ألا ترى أنّ النبيّ عليه الصلاة والسلام قال: "عفوت عنكم عن صَدَقة الخيل" فليس العفو هاهنا عن استحقاق، ويكون معناه تركت أن أُوجِب عليكم الصّدقةَ في الخيل. ومن الباب العافية: دِفاع الله تعالى عن العبد، تقول عافاه اللهُ تعالى من مكروهةٍ، وهو يعافيه معافاةً. وأعفاه الله بمعنى عافاه*. والاستعفاء: أن تطلب إلى مَن يكلِّفك أمراً أن يُعفِيَك منه. قال الشَّيباني: عفَا ظهرُ البعير، إذا تُرِك لا يُركَب وأعفيتُه أنا. ومن الباب: العِفاوة: شيء يُرفَع من الطعام يُتحَف به الإنسان. وإنِّما هو من العَفْو وهو الترك، وذلك أنّه تُرِك فلم يُؤكَل. فأمّا قول الكميت: وظَلّ غُلامُ الحيِّ طيّانَ ساغباً *** وكاعبُهم ذاتُ العِفاوةِ أسْغَبُ فقال قوم: كانت تعطي عفو المال فصارت تسغب لشدّة الزمان. وهذا بعيد، وإنّما ذلك من العِفاوة. يقول: كما يُرْفَعُ لها الطّعامُ تُتحَف به، فاشتدَّ الزّمانُ عليهم فلم يَفْعلوا ذلك. وأمّا العَافي من المرق فالذي يردُّه المستعير للقِدر. وسمِّي عافياً لأنّه يُترك فلم يؤكل. قال: * إذا رَدّ عافِي القدر مَن يستعيرها * ومن هذا الباب: العَفْو: المكان الذي لم يُوطأ. قال: قبيلةٌ كشِراك النَّعل دارجةٌ *** إنْ يَهبِطوا العَفْوَ لا يوجدْ لهم أَثرُ أي إنّهم من قلتهم لا يُؤثِّرون في الأرض. وتقول: هذه أرضٌ عَفْو: ليس فيها أثَر فلم تُرعَ. وطعامٌ عَفْو: لم يَمَسَّه قبلَك أحد، وهو الأُنُف. فأمَّا قولُهم عفا: درس، فهو من هذا؛ وذلك أنّه شيء يُترَك فلا يُتعهَّد ولا يُنزَل، فيَخفى على مرور الأيّام. قال لبيد: عَفَتِ الدِّيار محلُّها فمُقامها *** بمِنىً تأبَّد غَوْلُها فِرجامُها ألا تراه قال "تأبَّد" فأعْلَمَ أنَّه أتى عليه أبَدٌ. ويجوز أن يكون تأبَّد، أي أَلِفَتْه الأوابد، وهي الوحش. فهذا معنى العفو، وإليه يرجع كلُّ ما أشبهه. وقول القائل: عفا، درس، وعفا: كثُر -وهو من الأضداد- ليس بشيء، إنّما المعنى ما ذكرناه، فإذا تُرِك ولم يُتعهَّد حتّى خَفِيَ على مَرّ الدهر فقد عفا، وإذا تُرِك فلم يُقطَع ولم يُجَزَّ فقد عفا. والأصل فيه كلِّه التَّرك كما ذكرناه. ومن هذا الباب قولُهم: عليه العَفاء، فقال قومٌ هو التُّراب؛ يقال ذلك في الشَّتيمة. فإن كان صحيحاً فهو التُّراب المتروك الذي لم يُؤثَّر فيه ولم يُوطَأ؛ لأنّه إذا وُطِئ ولم يُترَك من المَشْي عليه تكدَّدَ فلم يكُ تراباً. وإن كان العَفاء الدّروس فهو على المعنى الذي فسّرناه. قال زُهير: تحمّل أهلُها عنها فبانُوا *** على آثارِ مَن ذَهَب العَفاءُ يقال عفَت الدار فهي تعفو عَفاءً، والرِّيح تعفو الدّار عَفاءً وعَفْواً. وتعفَّت الدّارُ تَعَفِّياً. قال ابنُ الأعرابيّ: العفو في الدّار: أن يكثُر التُّرابُ عليها حتّى يغطِّيَها. والاسم العَفاء، والعَفو. ومن الباب العِفو والعُفو، والجمع العِفاء، وهي الحُمُر الفِتاء، والأنثى عفوة والجمع عِفَوَة. وإنّما سمِّيت بذلك لأنَّها تُترك لا تُركَب ولا يُحمل عليها. فأمّا العِفَوَة في هذا الجمع فلا يُعلَم في كلام العرب واوٌ متحرِّكة بعد حرفٍ متحرّك في آخر البناء غير هذه، وذلك أنَّهم كرهوا أن يقولوا عِفَاةٌ. قال الفراء: العِفْوُ والعُفْو، والعِفْي والعُفْي: ولد الحمار، والأنثى عِفوة، والجمع عِفاء. قال: بضربٍ يُزيل الهامَ عن سَكِناتِه *** وطعنٍ كتَشهاق العَِفَا هَمَّ بالنّهْقِ ومن الباب العِفاء: ما كثُر من الوَبَر والرِّيش، يُقال ناقة ذات عِفاء، أي كثيرة الوَبَر طويلتُه قد كاد يَنْسِل. وسمِّي عِفاءً لأنّه تُرك من المَرْط والجَزّ. وعِفاء النّعامة: الرّيش الذي علا الزِّفّ الصّغار. وكذلك عِفاء الطَّير، الواحدةُ عِفاءة ممدود مهموز. قال: ولا يُقال للريشة عِفاءة حتى يكون فيها كثافةٌ. وقول الطِرمّاح: فيَا صُبحُ كَمِّشْ غُبَّرَ اللَّيلِ مُصْعِدا *** بِبَمِّ ونبّه ذا العِفاء الموشَّحِ إذا صاح لم يُخْذَل وجاوَبَ صوتَه*** حِماشُ الشَّوى يَصدحنَ من كلِّ مَصدَحِ فذو العِفاء: الرِّيش. يصف ديكاً. يقول: لم يُخذل، أي إنّ الدّيوكَ تجيبه من كلِّ ناحية. وقال في وَبَر الناقة: أُجُد موثّقة كأنّ عِفاءَها *** سِقطانِ من كنَفَيْ ظليمٍ نافرِ وقال الخليل: العِفاء: السَّحاب كالخَمْل في وجهه. وهذا صحيح وهو تشبيه، *إنما شبّه بما ذكرناه من الوَبر والريش الكثيفَين. وقال أهل اللغة كلُّهم: يقال من الشّعر عَفَوْته وعَفيْته، مثل قلوته وقليته، وعفا فهو عافٍ، وذلك إذا تركتَه حتى يكثُر ويَطُول. قال الله تعالى: {حَتَّى عَفَوْا} [الأعراف 95]، أي نَمَوْا وكثُرُوا. وهذا يدلُّ على ما قلناه، أنّ أصل الباب في هذا الوجه التّرك. قال الخليل: عفا الماء، أي لم يطأْه شيء يكدِّره. وهو عَفْوَة الماء. وعَفَا المَرعى ممن يحُلُّ به عَفَاءً طويلاً. قال أبو زيد: عَفْوَة الشّرَاب: خيره وأوفره. وهو في ذلك كأنّه تُرك فلم يُتَنَقَّص ولم يُتَخَوَّنْ. والأصل الآخر الذي معناه الطَّلَب قول الخليل: إنّ العُفاةَ طُلاّب المعروف، وهم المعتَفُون أيضاً. يقال: اعتفيتُ فلاناً، إذا طلبتَ معروفه وفَضْله. فإنْ كان المعروف هو العَفو فالأصلان يرجعان إلى معنىً، وهو الترك، وذلك أنّ العَفو هو الذي يُسمح به ولا يُحْتَجَن ولا يُمسَك عليه. قال أبو عمرو: أعطيته المال عَفْواً، أي عن غير مسألة. الأصمعيّ: اعتفاه وعَفَاهُ بمعنىً واحد، يقال للعُفاة العُفَّى. …………لا يَجدِبونني *** إذا هَرَّ دونَ اللحم والفَرث جازِرُهْ قال الخليل: العافية طُلاّب الرزق اسمٌ جامع لها. وفي الحديث: "مَن أحيا أرضاً ميْتَةً فهي له، وما أكَلَتِ العافِيَةُ [منها ] فهي له صَدَقةٌ". قال ابنُ الأعرابيّ: يقال ما أكثَرَ عافيةَ هذا الماء، أي واردتَه من أنواعٍ شتّى. وقال أيضاً: إبل عافية، إذا وردَت على كلأٍ قد وطئه النّاس، فإذا رعَتْه لم ترضَ به فرفعت رُؤُسَها عنه وطلبت غيرَه. وقال النَّضر: استعفت الإبل هذا اليَبِيسَ بمشافرها، إذا أخذَتْه من فوق التُّراب. (عفت) العين والفاء والتاء كلمة تدلُّ على كسر شيء، يقولون: عَفَتَ العظمَ: كَسَره. ثم يقولون العَفت في الكلام: كَسْرُه لُكنةً، ككلامِ الحبشيّ. (عفج) العين والفاء والجيم كلمتان: إحداهما عُضو من الأعضاء والآخر ضَرْبٌ. فالأولى الأعفاج: الأمعاء، ويقولون: إنّ واحدها عِفج وعَفْج. وأمّا الأخرى فيقال عَفَج، إذا ضَرَب. ويقال للخشبة التي يَضرب بها الغاسلُ الثِّياب: مِعفاج. وسائر ما يقال في هذا الباب مما لا أصل له. (عفر) العين والفاء والراء أصلٌ صحيح، وله معانٍ. فالأول لون من الألوان، والثاني نبت، والثالث شدّة وقُوّة، والرابع زَمان، والخامس شيءٌ من خَلْق الحيوان. فالأول: العُفرة في الألوان، وهو أن يَضرِب إلى غُبْرَة في حمرة؛ ولذلك سمّي التراب العَفَر. يقال: عفَّرت الشيءَ في التُّراب تعفيراً. واعتَفَر الشيء: سقَط في العَفَر. قال الشاعر يصف ذوائب المرأة، وأنّها إذا أرسلتها سقطَتْ على الأرض. تهلك المِدْراةُ في أكنافِه *** وإذا ما أرسَلتْه يَعْتفِرْ قال ابن دريد: العَفْر ظاهر تراب الأرض، بفتح الفاء، وتسكينها. قال: "والفتح اللُّغة العالية". ويقال للظّبي أعفَرُ للونهِ. قال: يقول ليَ الأنباط إذْ أنا ساقطٌ *** به لا بظبيٍ في الصَّريمة أعفرا قال: وإنما ينسب إلى اسم التُّراب. وكذلك الرَّمْل الأعفر. قال: واليَعْفُور الخِشْف، سمِّي بذلك لكثرة لُزوقه بالأرض. قال ابن دريد: "العَفِير لحمٌ يجفَّف على الرَّمل في الشمس". ومن الباب: شرِبت سَويقاً عَفِيراً، وذلك إذا لم يُلَتَّ بزَيت ولا سَمن. فأمَّا الذي قاله ابن الأعرابيّ، من قولهم: "وقعوا في عافور شرّ" مثل عاثور، فممكن أن يكون من العَفَر، وهو التُّراب، وممكن أن يكون الفاء مبدلة من ثاء. وقد قال ابنُ الأعرابيّ: إنّ ذلك مشتقٌّ من عَفّرَه، أي صرعه ومرَّغه في التراب. وأنشد: * جاءت بشرٍّ مَجْنَبٍ عافورِ * فأمّا ما رواه أبو عبيدة أنّ العَفْر: بذر الناس الحبوب، فيقولون عَفَروا أي بذروا، فيجوز أن يكون من هذا؛ لأنّ ذلك يلقى في التُّراب. قال الأصمعيّ: ورُوِي في حديث عن هلالِ بن أميّة: "ما قَرِبْت امرأتي منذ عَفّرنا". ثم يحمل على هذا العَفَار، وهو إبَار النَّخل وتلقيحه. وقد قيل في عَفار النخل غيرُ هذا، وقد ذُكِر في موضعه. وقال ابن الأعرابيّ: العُفْر: الليالي البِيض. ويقال لليلةِ ثلاثَ عشرةَ من *الشَّهر عَفْراء، وهي التي يقال لها ليلة السَّوَاء. ويقال إنّ العُفْر: الغنمُ البِيض الجُرد، يقال قوم مُعْفِرُون ومضيئون. قال: وهذيل مُعْفِرَة، وليس في العرب قبيلة مُعْفِرَة غيرها. ويقولون: ما على عَفَر الأرض مثلُه، أي على وجهها. ومن الباب أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا سَلّم جافَى عَضُديه عن جَنْبيه حتَّى يُرَى من خلفه عُفْرةُ إبطَيْه. وأمّا الأصل الثاني فالعَفار، وهو شجرٌ كثير النّار تُتَّخذ منه الزِّناد، الواحدة عَفارة. ومن أمثالهم: "اقدَحْ بعَفارٍ أو مَرْخ، واشدُد إن شئت أو أرْخ". قال الأعشى: زنادُك خيرُ زِناد الملو *** كِ خالَطَ منهنّ مرْخٌ عَفارا ولعلَّ المرأة سمِّيت "عَفَارة" بذلك. قال الأعشى: بانَت لتَحزُنَنا عَفارَهْ *** يا جارتا ما أنتِ جارهْ وكذلك "عُفيرة ". وقال بعضهم: العُفُر: جمع العَفار من الشَّجر الذي ذكرناه. وأنشدوا: قد كان في هاشمٍ في بيت محضِهِم *** وارى الزِّناد إذا ما أصْلَد العُفُر ويقولون: "في كلِّ شجرٍ نار، واستَمْجَد المَرْخُ والعَفار"، أي إنَّهما أخذا من النّار ما أحْسَبَهُما. والأصل الثالث: الشِّدّة والقوّة. قال الخليل: رجل عِفْرٌ بيِّنُ العَفارة، يوصَف بالشَّيطنة، ويقال: شَيطانٌ عِفْرِيَة وعفريت، وهم العفاريَةُ والعفاريت. ويقال إنّه الكَيِّس الظَّريف. وإن شئتَ فعِفْرٌ وأعفارٌ، وهو المتمرّد. وإنِّما أُخِذ من الشّدّة والبَسالة. يقال للأسد عِفِرٌّ وعَفرْنَى، ويقال للخبيث عِفِرِّينُ، وهم العِفِرُّون. وأسَد عَفَرنَى ولبؤة عَفَرناة، أي شديدة. قال: بِذاتِ لَوْثٍ عَفْرناةٍ إذا عَثَرت *** فالتَّعسُ أدنَى لها من أن أقول لَعا ويسمُّون دويْبَّة من الدّوابّ "ليث عِفِرّين"، وهذا يقولون إنّ الأصل فيه البابُ الأوّل؛ لأنَّ مأوَى هذه الدويْبَّة التُّراب في السهل، تدوِّر دارةً ثم تندسُّ في جوفها، فإذا هِيجَ رمَى بالتُّراب صُعُدا. قال الخليل: ويسمُّون الرّجُل الكاملَ من أبناء الخمسين: ليث عِفِرّين. يقولون: "ابنُ العَشْر لعّابٌ بالقُلِين، وابنُ العِشرين باغي نِسِين، وابن ثلاثين أسعى السَّاعين، وابن الأربعين أبطش الباطشين، وابن الخمسين ليثُ عِفِرِّين، وابن ستِّين مؤْنس الجلِيسِين، وابن السبعين أحكم الحاكمين، وابن الثَّمانين أسرع الحاسبين؛ وابن التسعين واحدُ الأرذَلِين، وابن المائة لا جاء ولا ساء"، يقول: لا رجلٌ ولا امرأة. قال أبو عُبيد: العِفريَة النفريَة: الخبيث المنكر. وهو مِثل العِفْر، يقال رجل عِفْرٌ، وامرأة عِفرة. وفي الحديث: "إنَّ الله تعالى يُبغِض العِفريَة النِّفرية، الذي لم يُرْزَأ في ماله وجسمه". قال: وهو المصحَّح الذي لا يكاد يَمرَض. وزعم بعضُهم أن العَفَرفَر مثل العَفَرنَى من الأُسود، وهو الذي يَصرع قِرنَه ويَعفِر. فإذا كان صحيحاً فقد عاد هذا البابُ إلى الباب الأوّل. وأنشد: إذا مشَى في الحَلَق المُخَصَّرِ *** وبَيْضَةٍ واسعةٍ ومِغفرِ يَهُوس هَوسَ الأسدِ العَفَرفرِ ويقال إنَّ عَفَار: اسم رجل، وإنَّه مشتق من هذا، وكان يُنسب إليه النِّصال. قال: نصلٌ عَفارِيٍّ شديدٍ عَيرُه ويقال *** لم يبق مِِ النِّصال عادٍ غَيرُه للعِفِرّ عُفارية أيضاً. قال جرير: قَرنْتُ الظَّالمِينَ بمرمريسٍ *** يذلُّ لـه العُفارِيَة المَريدُ والأصل الرَّابع من الزَّمان قولُهم: لقيته عن عُفْر: أي بعد شهر. ويقال للرّجُل إذا كان له شرف قديم: ما شرفُك عن عُفْر، أي هو قديم غير حديث. قال كُثَيِّر: ولم يك عن عَفْرٍ تفرُّعُك العُلَى *** ولكنْ مواريثُ الجدودِ تَؤُولُها أي تُصلِحها وترُبُّها وتَسُوسها. ويقال في عَفار النخل: إنَّ النّخلَ كان يُترَك بعد التَّلقيح أربعين يوماً لا يُسقَى. قالوا: ومن هذا الباب التّعفير: وهو أن تُرضع المُطْفِلُ ولدَها ساعةً وتتركه ساعة. قال لَبيد: لِمُعَفَّر قَهْدٍ* تنازَعَ شِلْوَهُ *** غُبْرٌ كواسِبُ لا يُمنُّ طعامها وحُكي عن الفَرّاء أن العَفِير من النِّساء هي التي لا تُهدي لأحدٍ شيئاً. قال: وهو مأخوذٌ من التّعفير الذي ذكرناه. وهذا الذي قاله الفرّاء بعيدٌ من الذي شبّه به، ولعلَّ العفير هي التي كانت هدِيّتها تدوم وتَتَّصل، ثم صارت تهدى في الوقت. وهذا على القياس صحيح، ومما يدلُّ على هذا البيتُ الذي ذكر الفرّاء للكميت: وإذا الخُرَّد اغبَرَرْن من المحْـ *** ـلِ وصارت مِهداؤُهن عَفِيرا فالمِهداء التي مِن شأنها الإهداء، ثم عادت عَفيراً لا تُديم الهديَّة والإهداء. وأمّا الخامس فيقولون: إنَّ العِفرِيَة والعِفْراة واحدة، وهي شَعَر وسط الرّأس. وأنشد: قد صَعَّد الدّهرُ إلى عِفراتِه *** فاحتصَّها بشفرتَيْ مِبراتِه وهي لغة في العِفريَة، كناصِيَة وناصاة. وقد يقولون على التّشبيه لعرف الديك: عِفريَة. قال: * كعِفريَة الغَيورِ من الدَّجاجِ * أي من الدِّيَكة. قال أبو زيد: شعر القفا من الإنسان العِفرِيَة. (عفز) العين والفاء والزاء ليس بشيء، ولا يُشبِه كلامَ العرب. على أنهم يقولون: العَفْز: ملاعَبة الرّجلِ امرأتَه، وإنّ العَفْز: الجَوز. وهذه لا معنى لذكره. (عفس) العين والفاء والسين أصل صحيح يدلُّ على ممارسَة ومعالَجة. يقولون: هو يعافس الشّيء، إذا عالَجَه. واعتفَسَ القومُ: اصطرعوا. وعُفِسَ، إذا سُجِن. وهذا على معنى الاستعارة، كأنَّه لما حُبِس كان كالمصروع. والمعفوس: المبتَذَل. والعَفْس: سَوق الإبل. والمعنى في ذلك كلِّه متقارب. (عفص) العين والفاء والصاد أُصَيل يدلُّ على التواءٍ أوْ لَيٍّ. يقال: عَفَص يدَه: لوَاها. ويقولون: العَفَص: التواء في الأنف. (عفط) العين والفاء والطاء أُصَيْل صحيح يدلُّ على صُوَيت، ثم يحمل عليه. يقولون: العَفْطَة: نَثْرة الضائنة بأنفها. يقال: "ما لـه عافطة ولا نافطة". ويقال إنّ العافطة الأمَة، والنافطة الشّاة. ثم يقولون للألْكَن العِفطِيّ ويقولون: عَفَط بغنمه، إذا دعاها. والله أعلم بالصواب.
(عقل) العين والقاف واللام أصلٌ واحد منقاس مطرد، يدلُّ عُظْمُه على حُبْسة في الشَّيء أو ما يقارب الحُبْسة. من ذلك العَقْل، وهو الحابس عن ذَميم القَول والفِعل. قال الخليل: العَقل: نقيض الجهل. يقال عَقَل يعقِل عَقْلا، إذا عرَفَ ما كان يجهله قبل، أو انزجَر عمّا كان يفعلُه. وجمعه عقول. ورجل عاقلٌ وقوم عُقَلاء. وعاقلون. ورجل عَقُول، إذا كان حسَنَ الفَهم وافر العَقْل. وما له مَعقولٌ، أي عقل؛ خَرج مَخرجَ المجلود للجَلادة، والمَيْسور لليُسْر. قال: فقد أفادت لهم عقلاً وموعِظةً *** لمن يكون لـه إرْبٌ ومعقولُ ويقال في المثل: "رُبَّ أبْلَهَ عَقول". ويقولون: "عَلِمَ قتيلاً وعَدِم معقولاً". ويقولون: فلانٌ عَقُولٌ للحديث، لا يفلت الحديث سَمْعُه، ومن الباب المَعقِل والعَقْل، وهو الحِصن، وجمعه عُقول. قال أحيحَة: وقد أعددت للحِدْثان صَعْباً *** لو أنّ المرءَ تنفعُه العقُول يريد الحصون. ومن الباب العَقْل، وهي الدِّيَة. يقال: عَقَلْتُ القتيلَ أعْقِله عقلاً، إذا أدّيتَ ديَته. قال: إنِّي وقتلي سُلَيكاً ثمَّ أَعْقِلَه *** كالثّور يُضرَب لمّا عافت البقرُ الأصمعيّ: عقلت القتيلَ: أعطيتُ دِيتَه. وعقَلت عن فلانٍ، إذا غَرِمْتَ جنايتَه. قال: وكلَّمت أبا يوسف القاضيَ في ذلك بحضرة الرشيد، فلم يفرِق بين عَقَلته وعقَلت عنه، حتَّى فَهَّمْته. والعاقلة: القوم تُقَسَّم عليهم الدّية في أموالهم إذا كان قتيلُ خطأ. وهم بنو عمِّ القاتل الأدنَون وإخوتُه. قال الأصمعيّ: صار دم فلان مَعْقُلة على قومه، أي صاروا يَدُونه. ويقول بعض العلماء: إن المرأة تُعاقِل الرّجُلَ إلى ثلث ديتها*. يعنون أنّ مُوضِحتَها وموضحتَهُ سواء، فإذا بلغ العَقْلُ ما يزيد على ثُلث الدية صارت ديةُ المرأة على نصف دِيَة الرّجل. وبنو فلانٍ على معاقلهم التي كانوا عليها في الجاهلية، يعني مراتبَهم في الدِّيات، الواحدة مَعْقُلة. قالوا أيضاً: وسمِّيت الدّية عَقْلاً لأنّ الإبل التي كانت تُؤخَذ في الدِّيات كانت تُجمَع فتُعقَل بفناء المقتول، فسمِّيت الدّيةُ عقلاً وإن كانت دراهم ودنانير. وقيل سمِّيت عقلاً لأنَّها تُمْسِك الدّم. قال الخليل: إذا أخذ المصَدِّق صدقةَ الإبل تامّةً لسنة قيل: أخذ عقالاً، وعقالين لسنتين. ولم يأخذ نقداً، أي لم يأخذ ثمناً، ولكنه أخَذَ الصّدقةَ على ما فيها. وأنشد: سعى عقالاً فلم يترُكْ لنا سَبَداً *** فكيف لو قد سعى عمروٌ عِقالينِ وأهل اللغة يقولون: إنَّ الصّدقة كلَّها عِقال. يقال: استُعمِل فلانٌ على عِقال بني فلان، أي على صدقاتهم. قالوا: وسمِّيت عقالاً لأنّها تَعقِل عن صاحبها الطَّلبَ بها وتَعقِل عنه المأثَمَ أيضاً. وتأوَّلُوا قولَ أبي بكر لمَّا منعت العربُ الزكاةَ "والله لو منعوني عِقالاً ممّا أدّوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتُهم عليه"، فقالوا: أراد به صدقةَ عام، وقالوا أيضاً: إنما أراد بالعِقال الشَّيء التافِه الحقير، فضَرَب العِقال الذي يُعقَل به البعير لذلك مثلاً. وقيل إنّ المصدِّقَ كان إذا أعطى صدقة إبلِهِ أعطى معها عُقُلها وأرويَتَها. قال الأصمعيّ: عَقَل الظّبي يَعْقِلُ عُقولاً، إذا امتنع في الجبل. ويقال: عَقَل الطَّعامُ بطنَه، إذا أمسَكَه. والعَقُولُ من الدّواء: ما يُمسِك البطن. قال: ويقال: اعتقل رمحَه، إذا وضَعَه بين رِكابه وساقه. واعتقَلَ شاتَه، إذا وضعَ رجلَها بين فخذه وساقه فحلبها. ولفلان عُقْلة يَعتقِل بها النّاسَ، إذا صارعَهم عَقَلَ أرجُلَهم. ويقال عقَلْت البَعيرَ أعقِلُه عقلاً، إذا شَدَدتَ يدَه بعِقاله، وهو الرِّباط. وفي أمثالهم: * الفحلُ يحمي شولَه معقولا * واعتُقل لسانُ فلانٍ، إذا احتبس عن الكلام. فأمّا قولُهم: فلانةُ عقيلةُ قومِها، فهي كريمتُهم وخيارهم. ويُوصَف بذلك السيِّد أيضاً فيقال: هو عقيلة قومه. وعقيلةُ كلِّ شيءٍ: أكرمُه. والدُّرّة: عَقيلة البحر. قال ابنُ قيس الرُّقَيَّات: درّةٌ مِن عقائِل البحر بكرٌ *** لم يَشِنْها مَثاقب الّلآلِ وذُكِر قياس هذا عن ابن الأعرابيّ، قالوا عنه: إنما سمِّيت عقيلةً لأنها عَقَلت صواحبَها عن أن يبلُغْنها. وقال الخليل: بل معناه عُقِلت في خدرها. قال امرؤ القيس: عقيلة أخدانٍ لها لا دميمةٌ *** ولا ذات خُلْقٍ أن تأمَّلْتَ جَأْنَبِ قال أبو عبيدة: العقيلة، الذكر والأنثى سواء. قال: بَكْرٌ يُبذّ البُزْلَ والبِكارا *** عقيلةٌ من نُجُبٍ مَهَارَى ومن هذا الباب: العَقَل في الرّجلين: اصطكاك الرُّكبتين، يقال: بعيرٌ أعقُلُ، وقد عَقِل عَقَلاً. وأنشد: أخو الحَرْب لَبَّاسٌ إليها جِلالَها *** وليس بولاّج الخوالف أعقلا والعُقَّال: داء يأخذ الدوابَّ في الرِّجلين، وقد يخفف. ودابّة معقولة وبها عُقّال، إذا مشَتْ كأنَّها تَقلَع رجليها من صخرة. وأكثر ما يكون في ذلك في الشَّاء. قال أبو عبيدة: امرأة عَقْلاء، إذا كانت حَمْشة السّاقين ضخمةَ العضَلتين. قال الخليل: العاقول من النّهر والوادي ومن الأمور أيضاً: ما التبس واعوجَّ. وذكِر عن ابن الأعرابيّ، ولم نسمعه سماعاً، أنَّ العِقال: البئر القريبة القعر، سمِّيت عِقالاً لقُرْب مائها، كأنَّها تُستَقَى بالعِقال، وقد ذُكر ذلك عن أبي عبيدةَ أيضاً. ومما يقرب من هذا الباب العَقَنْقَل من الرَّمل، وهو ما ارتكم منه؛ وجمعه عقاقيل، وإنما سمِّي بذلك لارتكامه* وتجمُّعه. ومنه عَقنقَل الضّب: مَصِيرُه. ويقولون: "أطعِمْ أخاك من عقنقل الضَّبّ"، يُتَمثَّل به. ويقولون إنَّه طيِّب. فأمّا الأصمعيّ فإنّه قال: إنّه يُرمَى به، ويقال: "أطعم أخاك من عقنقل الضب" استهزاء. قالوا: وإنما سُمِّي عقنقلاً لتحوِّيه وتلوِّيه، وكلُّ ما تحوَّى والتوى فهو عَقنقَل، ومنه قيل لقُضْبان الكَرْم: عقاقيل، لأنَّها ملتوية. قال: نجُذّ رقابَ القومِ من كلِّ جانبٍ *** كجذِّ عقاقيل الكُرُومِ خبيرُها فأمّا الأسماء التي جاءت من هذا البناء ولعلَّها أن تكون منقاسة، فعاقِلٌ: جَبَل بعينه. قال: لمن الدِّيارُ برامتَينِ فعاقلٍ *** درسَتْ وغيَّرَ آيَها القَطْرُ قال أبو عبيدة: بنو عاقل رهط الحارث بن حُجْر، سُمُّوا بذلك لأنّهم نزلوا عاقلاً، وهم ملوك. ومَعْقلةُ: مكان بالبادية. وأنشد: وعينٍ كأنَّ البابليَّينِ لَبَّسَا *** بقلبك [منها] يوم مَعْقُلةٍ سِحرا وقال أوس: فبطنُ السُّليِّ فالسِّخالُ تَعَذَّرت *** فَمَعقُلةٌ إلى مُطارٍ فواحفُ قال الأصمعيّ: بالدَّهْناء خَبْرَاءُ يقال لها مَعْقُلة. وذو العُقَّال: فرسٌ معروف. وأنشد: فكأنما مسحوا بوجهِ حِمارِهم *** بالرَّقْمتين جَبِينَ ذي العُقّالِ (عقم) العين والقاف والميم أصلٌ واحد يدلُّ على غموضٍ وضيق وشِدّة. من ذلك قولهم حَرْبٌ عَقام وعُقَام: لا يَلوِي فيها أحدٌ [على أحد ] لشِدّتها. وداءٌ عَُقَامٌ: لا يُبرَأ منه. ومن الباب قولهم: رجل عَقام، وهو الضيِّق الخُلُق. قال: أنت عَقامٌ لا يُصابُ لـه هوَىً *** وذو همّة في المَطْلِ وهو مُضَيِّعُ ومن الباب عَقِمت الرّحمُ عُقماً، وذلك هَزْمَةٌ تقع في الرّحِم فلا تقبل الولَد. ويقال: عَقِمَت المرأة وعُقِمَت، وهي أجودُهما. وفي الحديث: "تُعقَم أصلابُ المنافقين فلا يقدِرون على السجود"، والمعنى يُبْسُ مفاصِلهم. ويقال رجلٌ عقيم، ورجال عُقَماء، ونسوةٌ معقومات وعقائم وعُقُم. قال أبو عمرو: عُقِمت المرأة، إذا لم تلد. قال ابنُ الأعرابي: عُقِمَت المرأة عَُقْماً، وهي معقومة وعقيم، وفي الرّجل أيضاً عُقِم فهو عقيم ومعقوم. وربما قالوا: عَقَمت فلانةَ، أي سحرتُها حتى صارت معقومةَ الرّحِم لا تَلِد. قال الخليل: عقلٌ عقيم، للذي لا يُجدي على صاحبه شيئاً. ويروى أنّ العقل عقلان: فعقل عقيمٌ، وهو عقل صاحب الدنيا؛ وعقلٌ مثمر، وهو عقل [صاحب] الآخرة. ويقال: المُلْك عقيم، وذلك أنّ الرّجلَ يقتلُ أباه على الملك، والمعنى أنّه يَسُدّ بابَ المحافظة على النّسب. والدنيا عقيم: لا تردُّ على صاحبها خيراً. والرِّيح العَقيم. التي لا تُلقِح شجراً ولا سَحاباً. قال الله تعالى: {وَفِي عَادٍ إذْ أَرْسَلْنَا عَليْهِمُ الرِّيحَ العَقِيم} [الذاريات 41]، قيل: هي الدَّبور. قال الكسائيّ: يقال عَقِمت عليهم الرّيح تَعقَم عُقْماً. والعقيم من الأرض: ما اعتقمتَها فحفَرْتها. قال: تزوَّدَ منّا بين أُذْناه ضَربةً *** دَعَتْه إلى هابي التُّراب عقِيم قال الخليل: الاعتقام: الحفر في جوانب البئر. قال ربيعة بن مقروم: وماءٍ آجِنِ الجَمّات قَفرٍ *** تَعقَّمُ في جوانبه السِّباعُ وإنما قيل لذلك اعتقامٌ لأنَّه في الجانب، وذلك دليل الضِّيقِ الذي ذكرناه. ومن الباب: المُعاقِم: المُخاصِم، والوجه فيه أنه يضيِّق على صاحبه بالكلام. وكان الشيبانيّ يقول: هذا كلام عُقْمِيّ، أي إنَّه من كلام الجاهلية لا يُعرف. وزَعم أنَّه سأل رجلاً من هُذيل يكنى أبا عِياض، عن حرفٍ من غريب هُذيل، فقال: هذا كلامِ عُِقميّ، أي من كلام الجاهليّة لا يُتكلَّم به اليوم. ويقولون: إنّ الحاجز بين التِّبْن والحَبِّ إذا ذُرِّي الطعامُ مِعْقَم. (عقو) العين والقاف والحرف المعتل كلماتٌ لا تنقاس وليس يجمعُها أصلٌ، وهي صحيحة. وإحداها العَقْوة: ما حولَ الدّار. يقال ما يَطُور بعَقْوَةِ فلانٍ أحد. والكلمة الأخرى: العِقْيُ: ما يخرُج من بطن الصبيّ حين يُولَد. والثالثة: العِقْيان، *وهو فيما يقال: ذهبٌ ينبت نباتاً، وليس مما يحصَّلَ من الحِجارة. والاعتقاء مثل الاعتقام في البئر، وقد ذكرناه. ويقال عَقَّى الطائر، إذا ارتفع في طيرَانه. وعقَّى بسهمه في الهواء. وينشد: عَقَّوْا بسهم فلم يَشعُر به أحدٌ *** ثم استفاؤوا وقالوا حبّذا الوَضَحُ ومن الكلمات أعقى الشَّيءُ، إذا اشتدَّت مرارتُه. (عقب) العين والقاف والباء أصلانِ صحيحان: أحدُهما يدلُّ على تأخير شيء وإتيانِه بعد غيره. والأصل الآخَر يدلُّ على ارتفاعٍ وشدّة وصُعوبة. فالأوّل قال الخليل: كلُّ شيء يَعقُبُ شيئاً فهو عَقيبُه، كقولك خَلفٍ يَخلف، بمنزلة اللَّيل والنهار إذا مضى أحدُهما عَقَبَ الآخَر. وهما عَقيبانِ، كلُّ واحدٍ منهما عَقيبُ صاحبِه. ويعقِّبان، إذا جاء اللّيلُ ذهب النَّهارُ، فيقال عَقَّب اللّيلُ النّهارُ وعقّب النهارُ اللّيل. وذكر ناسٌ من أهل التفسير في قوله تعالى:{لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه} [الرعد 11] قال: يعني ملائكةَ اللّيلِ والنّهار، لأنهم يتعاقبون. ويقال إنَّ العَقِيب الذي يعاقب آخَرَ في المركَب، وقد أعقَبْتُه، إذا نزلْتَ ليركب. ويقولون: عَقِبَ عليَّ في تلك السِّلعة عَقَب، أي أدركني فيها دَرَكٌ. والتَّعقِبَة: الدَّرَك. ومن الباب: عاقبت الرجل مُعاقَبة وعُقوبةً وعِقاباً. واحذَر العقوبةَ والعَقب. وأنشَد: فنعمَ والِي الحُكْمِ والجارُ عمر *** لَيْنٌ لأهل الحقِّ ذَوَ عَقْبٍ ذكَرْ ويقولون: إنّها لغةُ بني أسد. وإنّما سمِّيت عقوبة لأنَّها تكون آخراً وثانيَ الذَّنْب. وروي عن [ابن] الأعرابيّ: المعاقِب الذي أدْرك ثأره. وإنَّما سمي بذلك للمعنى الذي ذكرناه. وأنشد: ونحنُ قَتلنا بالمُخارِق فارساً *** جزاءَ العُطاسِ لا يموتُ المعاقِبُ أي أدركنا بثأره قَدْرَ ما بين العُطاس والتّشميت. ومثله: ففَتلٌ بقَتلانا وجَزٌّ بجَزّنا *** جزاءَ العُطاسِ لا يموت مَن اتّأرْ قال الخليل: عاقبةُ كلِّ شيءٍ: آخره، وكذلك العُقَب، جمع عُقْبة. قال: * كنتَ أخي في العُقَبِ النَّوائب * ويقال: استعقَبَ فلانٌ من فِعلهِ خيراً أو شرَّاً، واستعقَبَ من أمرهِ ندماً، وتَعقَّب أيضاً. وتعقَّبْت ما صنَعَ فلانٌ، أي تتبَّعت أثره. ويقولون: ستَجِد عقِبَ الأمر كخيرٍ أو كشرٍّ، وهو العاقبة. ومن الباب قولهم للرجل المنقطع الكلام: لو كان له عَقِبٌ تكلّم، أي لو كان عنده جواب. و قالوا في قول عمر: فلا مالَ إلاَّ قد أخذنا عقابَه *** ولا دمَ إلاّ قد سفكنا به دَما قال: عِقابَه، أراد عُقباه وعُقْبانَه. ويقال: فلانٌ وفلانٌ يعتقبان فلاناً، إذا تعاوَنَا عليه. قال الشَّيباني: إبلٌ معاقِبَةٌ: تَرْعَى الحَمْضَ مَرّةً، والبقلَ أخرى. ويقال: العواقب من الإبل ما كان في العِضاهِ ثم عَقَبَتْ منه في شجر آخر. قال ابنُ الأعرابيّ: العواقب من الإبل التي تُداخِل الماءَ تشربُ ثم تعود إلى المَعْطِن ثم تعود [إلى الماء ] وأنشد يصف إبلاً: * روابع خَوامس عواقب * وقال أبو زياد: المعقِّبات: اللواتي يَقُمن عند أعجاز الإِبل التي تعترك على الحوض، فإذا انصرفَتْ ناقةٌ دخلت مكانَها أخرى، والواحدةُ مُعَقِّبة. قال: * الناظراتُ العُقَب الصَّوادِف * وقالوا: وعُقْبة الإبل: أن ترعى الحَمض [مَرَّةً] والخَلّة أخرى. وقال ذو الرُّمَّة: ألْهاهُ آءٌ وتَنُّومٌ وعُقْبتُه *** مِن لائح المرو والمرعى لـه عُقَب قال الخليل: عَقبت الرّجُل، أي صرت عَقِبَه أعقُبه عَقْبا. ومنه سمِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العاقب" لأنَّه عَقبَ مَن كان قبلَه من الأنبياء عليهم السلام. وفعلْتُ ذلك بعاقبةٍ، كما يقال بآخِرة. قال: أرَثَّ حديثُ الوصلِ من أمِّ مَعبدِ *** بِعاقبةٍ وأخلفَتْ كلَّ مَوعِد وحكي عن الأصمعيّ: رأيتُ عاقبةً من الطَّير، أي طيراً يَعقُب بعضها بعضاً، تقع هذه مكانَ التي قد كانت طارت قبلَها. قال أبو زيد: جئتُ في عُقب الشهر وعُقْبانِه، أي بعد مُضِيِّه، العينان مضمومتان. قال: وجئت في عَقب الشهر وعُقبه [و]* في عُقُبِه. قال: [وقد] أروح عُقُبَ الإصدار *** مُخَتَّراً مسترخِيَ الإزارِ قال الخليل: جاء في عَقِب الشهر أي آخرِه؛ وفي عُقْبه، إذا مضى ودخل شيءٌ من الآخر. ويقال: أخذت عُقْبَةً من أسيرِي، وهو أن تأخذ منه بدلاً. قال: * لا بأس إنِّي قد عَلِقت بعُقْبة * وهذا عُقْبةٌ من فلانٍ أي أُخِذَ مكانه. وأمّا قولهمِ عُِقْبَةُ القمر.... ومن الباب قولهم: عُقبْة القِدر، وهو أن يستعير القِدرَ فإذا ردَّها ترك في أسفلها شيئاً. وقياس ذلك أن يكون آخرَ ما في القدر، أو يبقى بعد أن يُغرف منها. قال ابن دريد: إذا عُقَب القُدور يكنَّ مالاً *** تحبّ حلائلَ الأقوام عِرسي وقال الكميت: ……………ولم يكن *** لعُقْبةِ قِدرِ المستعيرين مُعْقِبُ ويقولون: تصدَّقْ بصدقةٍ ليست فيها تَعقِبة، أي استثناء. وربّما قالوا: عاقب بين رجليه. إذا راوَحَ بينهما، اعتمد مرّةً على اليمنى ومرّةً على اليُسرى. وممّا ذكره الخليل أن المِعقاب: المرأة التي تلد ذكراً بعد أنثى، وكان ذلك عادتَها. وقال أبو زيد: ليس لفُلان عاقبة، يعني عَقِباً. ويقال عَقَب للفرس جَرْيٌ بعد جري، أي شيءٌ بعد شيء. قال امرؤ القيس: على العَقْبِ جياشٌ كأنَّ اهتزامَه *** إذا جاش منه حَمْيُه غَلْيُ مِرجلِ وقال الخليل: كلُّ مَن ثَنَّى شيئاً فهو معقِّب قال لبيد: حَتَّى تَهَجَّرَ للرّواح وهاجَها *** طَلَب المعقِّبِ حقَّه المظلوم قال ابن السّكيت: المعَقِّب: الماطِل، وهو هاهنا المفعول به، لأنَّ المظلوم هو الطالب، كأنّه قال: طلب المظلوم حَقّه من ماطله. وقال الخليل: المعنى كما يطلب المعقِّبُ المظلومَ حقَّه، فحمل المظلومَ على موضع المعقِّب فرفعه. وفي القرآن: {وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ} [النمل 10]، أي لم يعطف. والتَّعقيب، غزوة بعد غزوة. قال طفيل: وأطنابُه أرسانُ جُرْدٍ كأنَّها *** صدورُ القنا من بادئٍ ومُعقِّبِ ويقال: عقَّبَ فلانٌ في الصَّلاة، إذا قام بعد ما يفرُغ النّاسُ من الصَّلاة في مجلِسه يصلِّي. ومن الباب عَقِبُ القدَم: مؤخَّرها، وفي المثل: "ابنُكِ مَن دَمَّى عَقِبيكِ"، وكان أصل ذلك في عَقيل بن مالك، وذلك أن كبشة بنت عُروة الرّحّال تبَنَّتْه، فعرَم عقيلٌ على أمِّه يوماً فضربته، فجاءتها كبشةُ تمنعها، فقالت: ابني ابني، فقالت القَينيَّة - وهي أمَةٌ من بني القَين-: "ابنُكِ من دَمَّى عَقِبيكِ"، أرى ابنك هو الذي نُفِسْتِ به ووَلَدْتِه حَتّى أدمى النّفاس عَقِبَيْك، لا هذا. ومن كلامهم في العُقوبة والعِقاب، قال امرؤ القيس: * وبالأشْقَينَ ما كان العقابُ * ويقال: أعقب فلانٌ، أي رجَع، والمعنى أنه جاء عُقَيب مضيّه. قال لبيد: فجال ولم يُعْقِب بغُضْفٍ كأنَّها *** دُقاق الشَّعيل يبتدِرْن الجعائلا قال الدريدي: المُعْقب: نجم يعقُب نجماً آخَر، أي يطلُع بعده. قال: * كأنها بينَ السُّجوف مُعْقِبُ * ومن الباب قولهم: عليه عُقْبَة السَّرْو والجمال، أي أثره. قال: وقومٌ عليهم عُِقْبة السَّرْو... وإنما قيل ذلك لأنَّ أثَرَ الشَّيء يكونُ بعد الشيء. وممّا يتكلمون به في مجرى الأمثال قولهم: "من أين جاءت عَقِبُك" أي من أين جئت. و"فلانٌ مَوَطَّأ العَقِب" أي كثير الأتباع. ومنه حديث عمّار: "اللهُمَّ إن كان كَذَب فاجعله مُوطّأَ العَقِب". دعا أن يكون سلطاناً يطأ النّاس عَقِبه، أي يتبعونه ويمشون وراءَه، أو يكون ذَا مالٍ فيتبعونه لمالِه. قال: عهدي بقيسٍ وهُمُ خير الأمَمْ *** لا يطؤون قدماً على قَدَمْ أي إنَّهم قادةٌ يتبعهم الناس، وليسوا أتباعاً يطؤون أقدامَ مَن تقدَّمهم. وأما قول النَّخَعي: "المعتقب ضامنٌ لما اعتَقب" فالمعتقِب: الرجل يَبيع الرّجُلَ شيئاً فلا ينقدُه المشترِي الثّمَن، فيأبَى البائع أن يُسلِّم إليه السّلعة حتى ينقُده، فتضيعَ السّلعةُ عند البائع. يقول: فالضَّمان على البائع. وإنّما سُمِّي معتقباً لأنَّه أتى بشيء بعد البيع، وهو إمساك* الشَّيء. ويقولون: اعتقبت الشيء، أي حبَستُه. ومن الباب: الإعقابة: سِمَة مثل الإدبارة، ويكون أيضاً جلدةً معلّقة من دُبُر الأذن. وأمّا الأصل الآخر فالعَقَبة: طريقٌ في الجبل، وجمعها عِقابٌ. ثمّ رُدّ إلى هذا كلُّ شيءٍ فيه عُلوٌّ أو شدّة. قال ابنُ الأعرابيّ: البئر تُطوَى فيُعْقب وَهْيُ أواخِرها بحجارةٍ من خَلفْها. يقال أعقبت الطَّيَّ. وكلُّ طريقٍ يكون بعضُه فوقَ بعض فهي أَعْقاب. قال الكسائيّ: المعْقِب: الذي يُعْقب طَيّ البئر: أن يجعل الحصباءَ، والحجارةَ الصِّغار فيها وفي خللها، لكي يشدَّ أعقاب الطيّ. قال: * شدّاً إلى التَّعقيب مِن ورائها * قال أبو عمرو: العُقَاب: الخزَف الذي يُدخَل بين الآجُرّ في طيِّ البئر لكي تشتدّ. وقال الخليل: العُقَاب مرقىً في عُرْض جبل، وهو ناشزٌ. ويقال: العُقاب: حجرٌ يقوم عليه السّاقي، ويقولون إنّه أيضاً المَسِيل الذي يَسِيل ماؤه إلى الحَوض. ويُنشَد: كأنَّ صوتَ غَرْبِها إذَا انثَعَبْ *** سَيْلٌ على مَتْنِ عُقَابٍ ذي حَدَبْ ومن الباب: العَقَب: ما يُعْقَب به الرّماحُ والسِّهام. قال: وخِلافُ ما بينَه وبين العَصَب أنَّ العصَب يَضرِبُ إلى صُفرة، والعَقَب يضرِب إلى البياض، وهو أصلبُهما وأمتنُهما. والعَصَب لا يُنْتَفَع به. فهذا يدلّ على ما قلناه، أنَّ هذا البابَ قياسُه الشِّدَّة. ومن الباب ما حكاه أبو زيد: عَقِب العَرْفج يَعْقَب أشدَّ العَقَبِ. وعَقَبُه أن يَدِقَّ عُوده وتصفرَّ ثمرتُه، ثم ليس بعد ذلك إلاَّ يُبْسه. ومن الباب: العُقاب من الطَّير، سمِّيت بذلك لشدَّتها وقُوّتها، وجمعه أَعْقُبٌ وعِقبانٌ، وهي من جوارح الطَّير. ويقال عُقابٌ عَقَبناةٌ، أي سريعة الخَطفة. قال: عُقاب عَقَبْناةٌ كَأَنَّ وظيفَها *** وخُرطومَها الأعْلَى بنارٍ ملوَّحُ خرطومها: مِنْسَرها. ووظيفها: ساقُها. أراد أنَّهما أسودان. ثمّ شُبِّهت الرّاية بهذه العُقاب، كأنَّها تطير كما تَطير. (عقد) العين والقاف والدال أصلٌ واحدٌ يدلُّ على شَدٍّ وشِدّةِ وُثوق، وإليه ترجعُ فروعُ البابِ كلها. من ذلك عَقْد البِناء، والجمع أعقاد وعُقود. قال الخليل: ولم أسمع له فِعْلاً. ولو قيل عَقَّد تَعقِيداً، أي بنى عَقْداً لجاز. وعَقَدت الحبلَ أعقِده عَقْداً، وقد انعقد، وتلك هي العُقْدة. ومما يرجع إلى هذا المعنى لكنَّه يُزَاد فيه للفصل بين المعاني: أعقَدْت العَسَل وانعقد، وعسلٌ عقيد ومُنعقِد. قال: كأنّ رُبَّاً سال بعد الإعقادْ *** على لدِيدَيْ مُصْمَئِلٍّ صِلْخَادْ وعاقَدته مثل عاهدته، وهو العَقْد والجمع عُقود. قال الله تعالى: {أوْفُوا بالعُقود} [المائدة 1]، والعَقْد: عَقْدُ اليمين، [ومنه] قوله تعالى: {ولكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ} [المائدة 89]. وعُقْدَة النكاح وكلِّ شيء: وُجوبُه وإبرامُه. والعُقْدة في البيع: إيجابه. والعُقْدَة: الضَّيْعة، والجمع عُقَد. يقال اعتقد فلانٌ عُقْدةً، أي اتَّخذها. واعتقد مالاً وأخاً، أي اقتناه. وعَقَد قلبَه على كذا فلا يَنزِع عنه. واعتَقَد الشيءُ: صَلُب. واعتَقَد الإخاءُ: ثَبَتَ. والعَقِيد: طعام يُعْقَد بعسل. والمَعَاقِد: مواضع العَقْد من النِّظام. قال: * معاقِدُ سِلكِه لم تُوصَلِ * وعِقْدُ القِلادة ما يكون طُوَارَ العُنق، أي مقدارَه. قال الدريديّ: "المِعقاد خيط تنظم فيه خَرَزَات ". قال الخليل: عَقَد الرَّمل: ما تراكم واجتمع، والجمع أعقاد. وقلَّما يقال عَقِد وعَقِدات، وهو جائز. قال ذو الرّمّة: بين النهار وبين الليل من عَقَد *** على جوانبه الأسباط والهَدَبُ ومن أمثالهم: "أحمق من تُرْب العَقَد" يعنون عَقَد الرَّمل؛ وحُمْقُه أنّه لا يثبت فيه التّراب، إنما ينهار. و"هو أعطش من عَقَد الرّمْل"، و"أشْرَبُ من عَقَد الرّمل" أي إنّه يتشرَّب كلَّ ما أصابه من مطر ودَثَّة. * قال الخليل: ناقةٌ عاقدٌ، إذا عَقَدتْ . قال ابنُ الأعرابيّ: العُقْدة من الشّجر: ما يكفي المالَ سنَتَه. قال غيرُه: العُقْدَة من الشّجَر: ما اجتمع وثبَتَ أصلُه. ويقال للمكان الذي يكثر شجرُه عُقدة أيضاً. وكلُّ الذي قيل في عُقدة الشَّجَر والنَّبْت فهو عائد إلى هذا. ولا معنى لتكثير الباب بالتكرير. ويقولون: "هو آلَفُ من غُراب العُقْدة". ولا يطير غُرابها. والمعنى أنّه يجد ما يريده فيها. ويقال: اعتقدَت الأرضُ حَيَا سنَتِها، وذلك إذا مُطِرَت حتى يحفِر الحافر الثَّرَى فتذهبَ يدُه فيه حتى يَمَسَّ الأرض بأُذُنه وهو يحفر والثَّرَى جَعْد. قال ابنُ الأعرابيّ: عُقَد الدُّورِ والأرَضِينَ مأخوذةٌ من عُقَد الكلأ؛ لأنَّ فيها بلاغاً وكِفاية. وعَقَد الكَرْمُ، إذا رأيتَ عُودَه قد يَبس ماؤُه وانتهى. وعَقَدَ الإفطُ. ويقال إنّ عَكَد اللسان، ويقال لـه عَقَد أيضاً، هو الغِلَظ في وسطه. وعَقِد الرّجلُ، إذا كانت في لسانه عُقدة، فهو أعقَدُ. ويقال ظبيةٌ عاقدٌ، إذا كانت تَلْوي عنقَها، والأعقد من التُّيوس والظباء: الذي في قَرْنه عُقْدة أو عُقَد، قال النَّابغة في الظباء العواقد: ويضربن بالأيدي وراءَ بَرَاغِزٍ *** حسانِ الوجوه كالظِّباءِ العَوَاقِدِ ومن الباب ما حكاه ابن السكّيت: لئيمٌ أعقد، إذا لم يكن سهلَ الخلق. قال الطّرِمّاح: ولو أنِّي أشاء حَدَوْتُ قولاً *** على أعلامِه المتبيِّناتِ عشيرتُه لـه خِزْيَ الحَيَاةِ *** لأعْقَدَ مُقْرِف الطَّرَفين بَيْنِي يقال إنّ الأعقد الكلب، شبَّهه به. ومن الباب: ناقةٌ معقودة القَرَى، أي موَثَّقةُ الظهر. وأنشد: مُوَتَّرَة الأنساء معقودة القَرَى *** ذَقُوناً إذا كَلَّ العِتاق المرَاسِلُ وجملٌ عَقْدٌ، أي مُمَرُّ الخَلْقِ. قال النابغة: فكيفَ مَزارُها إلا بعَقْدٍ *** مُمَرٍّ ليس يَنْقُضُه الخَؤُونُ ويقال: تعقَّد السَّحابُ، إذا صار كأنّه عَقْد مضروبٌ مبنيّ. ويقال للرجل: "قد تَحلَّلت عُقَده"، إذا سكنَ غضبَهُ. ويقال: "قد عقد ناصيتَه"، إذا غَضِب فتهيَّأ للشَّر. قال: * بأسواط قومٍ عاقدِينَ النَّواصِيا * ويقال: تعاقَدت الكلابُ، إذا تعاظَلَت. قال الدريديّ: "عَقَّدَ فلان كلامَه، إذا عمَّاه وأعْوَصه ". ويقال: إنّ المعقِّد السّاحر. قال: يعقِّد سحرَ البابليَّيْنِ طرفُها *** مِراراً وتسقينا سُلافاً من الخَمْرِ وإنما قيل ذلك لأنّه يعقِّد السِّحر. وقد جاء في كتاب الله تعالى: {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ في الْعُقَد} [الفلق 4]: من السَّواحر اللواتي يُعقِّدن في الخُيُوط. ويقال إذا أطبق الوادي على قوم فأهلكهم: عقد عليهم. وممّا يشبه هذا الأصل قولُهم للقصير أعْقَد. وإنما قيل لـه ذلك لأنّه كأنّه عُقْدَة. والعُقْد: القِصَار. قال: ماذيّة الخُرْصان زُرق نصالها *** إذا سَدَّدُوها غير عُقْدٍ ولا عُصْلِ (عقر) العين والقاف والراء أصلان متباعدٌ ما بينهما، وكلُّ واحد منهما مُطَّرِدٌ في معناه، جامعٌ لمعاني فُروعه. فالأول الجَرْح أو ما يشبه الجَرح من الهَزْم في الشيء. والثاني دالٌّ على ثباتٍ ودوام. فالأوّل قول الخليل: العَقْرُ كالجَرْح، يقال: عَقَرت الفرسَ، أي كَسَعْتُ قوائمَه بالسَّيف. وفرسٌ عقير ومعقور. وخَيلٌ عَقْرَى. قال زياد: وإذا مررت بقبرِهِ فاعقِرْ به *** كُومَ الهِجان وكلَّ طِرفٍ سابحِ وقال لبيد: لَمَّا رأى لُبَدُ النُّسُورَ تطايرت *** رَفَع القوادمَ كالعقير الأعزلِ شبَّه النَّسرَ بالفرس المعقور. وتُعقَر النّاقة حتى تسقط، فإذا سقطت نَحَرَها مستمكناً منها. قال امرؤ القيس: ويوم عقَرتُ للِعذارى مَطِيَّتي *** فيا عجباً لرَحلِها المُتَحمِّلِ والعَقّار: الذي يعنُف بالإبل لا يرفُق بها في أقتابها فتُدْبِرها. وعَقَرْتُ ظهر الدابّة: أدبرته. قال ابن امرؤ القيس: تقول وقد مال الغبيطُ* بنا معاً *** عقَرْتَ بعيري يا امرأ القَيس فانزلِ وقول القائل: عَقَرْتَ بي، أي أطَلتَ حبسي، ليس هذا تلخيصَ الكلام، إنما معناه حَبَسه حتى كأنّه عقر ناقتَه فهو لا يقدِر على السَّير. وكذلك قول القائل: قد عقَرتْ بالقوم أمُّ الخزرجِ ويقال *** إذا مشَت سالت ولم تَدَحرجِ تَعقَّر الغَيث: أقام، كأنَّه شيء قد عُقِر فلا يَبْرَح. ومن الباب: العاقِرُ من النِّساء، وهي التي لا تَحمِل. وذلك أنّها كالمعقورة. ونسوةٌ عواقر، والفِعل عَقَرت تَعْقِر عَقْراً، وعقِرت تَعْقَر أحسن. قال الخليل: لأنَّ ذلك شيءٌ ينزل بها من غيرها، وليس هو من فِعلها بنفسها. وفي الحديث: "عُجُزٌ عُقَّر". قال أبو زيد: عَقَرت المرأةَ وعقِرَتْ، ورجل عاقر، وكان القياس عَقُرت لأنَّه لازم، كقولك: ظرُف وكرُم. وفي المثل: "أعقر من بَغلة". وقول الشاعر يصف عقاباً: لها ناهضٌ في الوكر قد مَهَّدت له *** كما مهَّدت للبَعْل حسناءُ عاقرُ وذلك أنَّ العاقرَ أشدُّ تصنُّعاً للزَّوج وأحفى به، لأنَّه [لا] وَلَدَ لها تدُلّ بها، ولا يَشغلُها عنه. ويقولون: لَقِحت الناقة عن عُقْر، أي بعد حِيال، كما يقال عن عُقْمٍ. وممّا حُمِل على هذا قولُهم لدِيةِ فَرْج المرأة عُقر، وذلك إذا غُصِبت. وهذا ممّا تستعمله العرب في تسمية الشيء باسم الشيء، إذا كانا متقاربَين. فسمِّيَ المهر عُقْراً، لأنَّه يُؤخذ بالعُقْر. وقولهم: "بيضة العُقْر" اسم لآخِر بيضةٍ تكون من الدَّجاجة فلا تبيضُ بعدها، فتضرب مثلاً لكل شيء لا يكون بعدَه شيءٌ من جِنْسه. قال الخليل: سمعت أعرابياً من أهل الصَّمَّان يقول: كلُّ فُرْجةٍ بين شيئين فهو عَقْر وعُقر، ووضع يدَه على قائمتي المائدة ونحن نتغدَّى فقال: ما بينهما عُقر. ويقال النخلة تُعْقَر، أي يُقطع رأسها فلا يخرج من ساقها أبداً شيء. فذلك العَقْر، ونخلة عَقِرَة. ويقال كَلأٌ عقار، أي يعقِر الإبلَ ويقتُلها. وأمّا قولهم: رفع عقيرتَه، إذا تَغنَّى أو قرأ، فهذا أيضاً من باب المجاورة، وذلك فيما يقال رجلٌ قُطِعت إحدى رجليه فرفَعَها ووضَعَها على الأُخرى وصَرَخ بأعلى صوته، ثمَّ قيل ذلك لكلِّ مَن رفع صوتَه. والعقيرة هي الرِّجل المعقورة، ولمَّا كان رفْعُ الصَّوت عندها سمِّي الصّوتُ بها. فأمّا قولُهم: ما رأيتُ عقيرةً كفلان، يراد الرَّجُل الشَّريف، فالأصل في ذلك أن يقال للرّجُل القتيل الكبير الخطير: ما رأيتُ كاليوم عَقِيرةً وسْطَ قوم! قال: إذا الخَيْل أجلى شاؤها فقد *** عقر خير من يَعقِره عاقر قال الخليل: يقال في الشَّتيمة: عَقْراً لـه وجَدْعاً. ويقال للمرأة حَلْقَى عَقْرى. يقول: عقرها الله، أي عَقَر جسدَها؛ وحَلَقها، أي أصابها بوجعٍ في حلقها. وقال قوم: تُوصَف بالشُّؤْم، أي إنَّها تَحلِق قَومَها وتعقِرهم. ويقال عَقَّرْتُ الرّجل، إذا قلتَ له: عَقْرَى حَلْقى.وحُكي عن بعض الأعراب: "ما نتشتُ الرُّقْعة ولا عَقَرتها" أي ولا أتيت عليها. والرُّقعة: الكلأ المتلبِّد. يقال كلؤُها يُنتَش ولا يُعْقَر. ويقولون: عُقَرة العلم النِّسيان، على وزن تُخَمة، أي إنّه يَعقِره. وأخلاط الدّواء يقال لها العقاقير، واحدها عَقّار. وسمّي بذلك لأنّه كأنّه عَقَر الجوف. ويقال العَقَر: داءٌ يأخذ الإنسان عند الرَّوع فلا يقدرُ أن يَبرحَ، وتُسْلِمُه رجلاه. قال الخليل: سَرْجٌ مِعْقَرٌ، وكلب عَقُور. قال ابن السِّكّيت: كلبٌ عَقُورٌ، وسَرْج عُقَرَةٌ ومِعْقَرٌ. قال البَعيث: * ألحَّ على أكتافِهم قَتبٌ عُقَرْ * ويقال سرج مِعْقَر وعَقّارٌ ومِعْقار. وأمّا الأصل الآخرَ فالعَقْر القصر الذي يكون مُعتَمداً لأهل القرية يلجؤون إليه. قال لبيد: كعَقْر الهاجريِّ إذِ ابْتناهُ *** بأشباهٍ حُذِينَ على مِثالِ الأشباه: الآجر؛ لأنّها مضروبةٌ على مِثال واحد. قال أبو عُبيد: العَقْر كلُّ بناء مرتفع. قال الخليل: عُقَر الدّار: مَحَلّة القَوم بين الدّار* والحوض، كان هناك بناءٌ أو لم يكن. وأنشد لأوس بن مَغْراء: أزمانَ سُقناهمُ عن عُقْر دارِهِم *** حتَّى استقرّ وأدناهُم لحَوْرانا قال: والعُقر أصل كلِّ شيء. وعُقْرُ الحوض: موقف الإبل إذا وردَتْ. قال ذُو الرُّمّةْ: بأعقارِه القِردانُ هَزْلَى كأنَّها *** نوادِرُ صَيصاء الهَبيدِ المحطّم يعني أعقار الحَوض. وقال في عقر الحَوض: فرماها في فرائِصها *** من إزاء الحوض أو عُقُرِه ويقال للنّاقة التي تَشرب من عُقْر الحوض عَقِرة، وللتي تشرب من إزائه أَزِيَة. ومن الباب عُقر النّار: مجتمع جَمرها. قال: وفي قَعر الكِنانة مرهفاتٌ *** كأنَّ ظُباتِها عُقُر بَعيج قال الخليل: العَقَار: ضَيعة الرَّجُل، والجمع العَقارات. يقال ليس له دارٌ ولا عَقارٌ. قال ابن الأعرابيّ: العَقار هو المتاع المَصُون، ورجلٌ مُعْقِر: كثير المتاع. قال أبو محمد القُتَيبيّ: العُقَيْرَى اسمٌ مبنيّ من عُقْرِ الدّار، ومنه حديث أم سلمة لعائشة: "سكّني عُقَيراكِ فلا تُصْحِريها "، تريد الْزَمِي بيتَك. ومما شُبّه بالعَقر، وهو القصر، العَقْر: غيمٌ ينشأ من قِبَل العَين فيغشَى عينَ الشمس وما حَولَها. قال حُميد: فإذا احزأَلَّت في المُناخِ رأيتَها *** كالعَقْر أفرَدَه العَماءُ الممطرُ وقد قيل إنّ الخمر تسمَّى عُقاراً لأنّها عاقرت الدَّنَّ، أي لازمَتْه. والعاقر من الرَّمل: ما يُنبت شيئاً كأنّه طحينٌ منخول. وهذا هو الأصل الثاني. وقد بقيت أسماءُ مواضعَ لعلَّها تكون مشتقَّة من بعض ما ذكرناه. من ذلك عَقَارَاء: موضع، قال حميد: رَكُودُ الحُميّا طَلَّةٌ شاب ماءَها *** بها من عَقَارَاء الكُروم رَبيبُ والعَقْر: موضعٌ ببابل، قتل فيه يزيد بن المهلَّب، يقال لذلك اليوم يومُ العَقْر. قال الطّرِمّاح: فخَرْتَ بيوم العَقر شرقيَّ بابلٍ *** وقد جَبُنت فيه تميم وقَلّتِ وعَقْرى: ماء. قال: ألاَ هل أتى سلمى بأنَّ خليلها *** على ماء عَقْرى فوق إحدى الرَّواحلِ (عقز) العين والقاف والزاء بناء ليس يشبه كلامَ العرب، وكذلك العين والقاف والسين، والقاف والشين، مع أنّهم يقولون العَقْش: بقلة أو نبتٌ. وليس بشيء. (عقص) العين والقاف والصاد أصلٌ صحيح يدلُّ على التواءٍ في شيء قال الخليل: العَقَص: التواءٌ في قرن التَّيس وكلِّ قرن. يقال كبشٌ أعقَصُ، وشاةٌ عَقْصاء. قال ابنُ دريد: العَقَص: كزَازة اليدِ وإمساكُها عن البَذْل. يقال: هو عَقِصُ اليدينِ وأعقَصُ اليدينِ، إذا كان كَزَّاً بخيلاً. قال الشَّيبانيّ: العَقِص من الرِّجال: المُلْتَوي الممتنع العَسِر، وجمعه أعقاص. قال: * مَارَسْت نَفْساً عَقِصاً مِراسُها * قال الخليل: العَقْص: أن تأخُذَ كلَّ خُصلة من شعرٍ فتلويَها ثم تعقِدَها حتى يبقى فيها التواءٌ، ثم ترسِلَها. وكلُّ خُصْلَةٍ عقيصة، والجمع عقائص وعِقاصٌ. ويقال عَقَصَ شَعْرَه، إذا ضَفَرَه وفتَله. [ويقال] العَقْصُ أن يَلْوِيَ الشَّعر على الرَّأْس ويُدخِل أطرافَه في أصوله، من قولهم: قرنٌ أعْقَصُ. ويقال لكل لَيَّةٍ عِقْصة وعَقيصة. قال امرؤ القيس: غدائرُه مستشزراتٌ إلى العُلَى *** تَضِلُّ العِقاصُ في مُثنَّى ومُرسَلِ ويقال: العِقاص الخَيط تُعقَص به أطراف الذّوائب. ومن الباب: العَقِص من الرِّمال: رملٌ لا طريقَ فيه. قال: كيف اهتدَتْ ودونها الجزائرُ *** وعَقِص من عالجٍ تَياهِرُ قال ابنُ الأعرابي: المِعْقَص: سهمٌ ينكسر نَصْله ويبقى سِنْخُه، فيُخرَج ويُضرب أصلُ النَّصل حتّى يطولَ ويردُّ إلى موضعه فلا يسدُّ الثَّقب الذي يكون فيه، لأنَّه قد دُقِّق؛ مأخوذٌ من الشاة العَقْصاء. ومن الحوايا واحدةٌ يقال لها العُقَيصاء. ويقولون: العَقِص: عُنق الكَرِش. وأنشد: هل عندكم مما أكلتمْ أمسِ *** من فَحِثٍ أو عَقِص أو رَأْسِ وقال الخليل في قول امرئ القيس: * تضلُّ العِقاصُ في مثنى ومُرسلِ * هي المرأةُ ربَّما* اتخذت عقيصةً من شعر غيرها تَضِلُّ في رأسها. ويقال: إنّه يعني أنّها كثيرةُ الشعر، فما عُقِص لم يتبيَّنْ في جميعه، لكثرة ما يبقى. (عقف) العين والقاف والفاء أصلٌ صحيح يدلُّ على عَطْفِ شيءٍ وحَنْيه. قال الخليل: عقفتُ الشّيءَ فأنا أُعقِفهُ عَقْفاً، وهو معقوف، إذا عطفتَه وحنوته. وانعقف هو انعقافاً، مثل انعطف. والعُقَّافة كالمِحجَن. وكلُّ شيءٍ فيه انحناءٌ فهو أعْقف. ويقال للفَقير أعقَف، ولعلّه سُمِّي بذلك لانحنائه وذِلَّته. قال: يا أيُّها الأعقَفُ المزجِي مطيَّتَه *** لا نعمةً [تبتغِي] عندي ولا نَشَبَا والعُقَاف: داءٌ يأخذ الشاة في قوائمها حتَّى تعوجّ، يقال شاةٌ عاقفٌ ومعقوفة الرِّجْلين. وربَّما اعترى كلَّ الدوابّ، وكلٌّ أعقف. وقال أبو حاتم: ومن ضروع البقر عَقُوف، وهو الذي يخالف شَخْبُهُ عند الحَلَب. ويقال: أعرابيٌّ أعقَفُ، أي مُحرَّم جافٍ لم يَلِنْ بعد، وكأنّه مُعَوّج بعدُ لم يستقِم. والبعير إذا كان فيه جَنَأٌ فهو أعقَفُ. والله أعلم.
(عكل) العين والكاف واللام أصلٌ صحيح يدلُّ على جمعٍ وضمّ. قال الخليل: يقال عَكَل السّائق الإبلَ يعكِلُ عَكْلاً، إذا ضمَّ قواصِيهَا وجَمَعها. قال الفرزدق: وهُمُ على شَرَف الأمِيل تَدارَكُوا *** نَعَماً تُشَلُّ إلى الرئيس وتُعكَلُ ويقال عكلتُ الإبل: حبستُها. وكلُّ شيء جمَعتَه فقد عكلتَه. والعَوكل: ظهر الكثيب المجتمع. قال: بكلِّ عقنقلٍ أو رأس بَرْثٍ *** وعَوكلِ كلِّ قَوزٍ مستطيلِ ويقال: العوكلة: العَظيمة من الرَّمْل. قال: * وقد قابلَتْهُ عوكلاتٌ عَوازِلٌ * فأمَّا قولهم: إنّ العَوْكلَ المرأةُ الحمقاء، فهو محمولٌ على الرَّمل المجتمع، لأنَّه لا يزال يَنهال، فالمرأةُ القليلةُ التّماسُك مشبَّهة بذلك، كما مَرَّ في تُرْب العَقِد. ويقال: العَوكل من الرِّجال: القصير. وذلك بمعنى التجمُّع. قال: * ليس بِراعي نَعَجاتٍ عَوكل * ويقال: إبلٌ معكولة، أي محبوسة مَعقولة. وهذا من القياسِ الصحيح. وعُكْلٌ: قبيلة معروفة. ومن الباب: عكلت المتاع بعضَه على بعضٍ، إذا نَضَدْتَه. (عكم) العين والكَاف والميم أصلٌ صحيح يدلُّ على ضمٍّ وجمعٍ لشيء في وعاءٍ. قال الخليل: يقال عَكَمْت المتاعَ أَعكِمُه عَكماً، إذا جمعتَه في وعاءٍ. والعِكمانِ: العِدلان يُشدَّانِ من جانبي الهَودج. قال: يا ربِّ زوِّجْني عجوزاً كبيرةً *** فلا جَدَّ لي يا ربِّ بالفَتَياتِ تحدِّثُني عمّا مضى من شبابها *** وتُطعِمُني من عِكْمِها تَمَراتِ ويقال في المثل للمتساويين: "وقَعَا كالعِكْمَين ". وأعْكَمت الرّجُل: أعنتُه على حَمل عِكْمه. وعاكمته: حملت معه. قال القُطاميّ في أعْكَمَ: إذا وَكّرتْ منها قطاةٌ سِقاءَها *** فلا تُعْكِمُ الأخرى ولا تستعينُها أي إنّها تَحمِل الماءَ إلى فراخها في حواصلها، فإذا ملأت حَوصلتَها لم تُعِن القطاةَ الأُخرى على حَمْلها. وتقول: أعكِمْني، أي أعِنِّي على حمل العِكْم. فإنْ أمرْتَه بحمله قلت: اِعكِمْني مكسورة الألف إن ابتدأت، ومدرجةً إن وصلت. كما تقول أَبْغِني ثوباً، أي أعنِّي على طَلبِه. ويقال عكّمَت النّاقةُ وغيرُها: [حَمَلت ] شحماً على شحم، وسِمَناً على سِمَن. واعتكم الشّيءُ وارتكَمَ، بمعنىً. وأمّا قولهم عَكَم عنه، إذا عَدَلَ جُبْناً، فهو من البابِ، لأنَّ الفَزِعَ إلى جانبٍ يَتَضَامُّ. وقال: ولاحَتْه مِن بعد الوُرودِ ظَمَاءَةٌ *** ولم يَكُ عن ورد المياه عَكُوما
أي لم ينصرِفْ ولم يتضامَّ إلى جانب. فأمَّا قولُه: فجال قلم يَعْكِم وشَيَّع إِِلفَه *** بمنقَطَع الغضراء شَدٌّ مُوالفُ فقوله: "لم يعكم" معناه لم يكُرَّ، لأنّ الكارَّ على الشيء متضامٌّ إليه. ويقال: ما عَكَمَ عن شتمي، أي ما انقبض. ومنه قول الهذليّ: أزُهيرُ هل عن شَيبةٍ من مَعْكِم *** أم لا خُلودَ لباذِلٍ متكرّمِ يريد بمعكِم: المَعْدِل. وأمّا قول الخليل* يقال للدابّة إذا شربت فامتلأ بطنُها: ما بقِيتْ في جوفها هَزْمة ولا عَكْمةٌ إلاّ امتلأت، فإنَّه يريد بالعَكْمة الموضعَ الذي يجتمع فيه الماء فيَرْوَى. والقياسُ واحد. قال: حتَّى إذا ما بلّت العُكوما *** من قَصَب الأجواف والهُزُوما ومن الباب: رجل مُعَكَّم، أي صُلب اللَّحم. (عكن) العين والكاف والنون أصلٌ صحيحٌ قريب من الذي قبله، قال الخليل: العُكَن: جمع عُكْنة، وهي الطَّيُّ في بطن الجارِية من السِّمَن. ولو قيلَ جاريةٌ عكْناء لجاز، ولكنهم يقولون: مُعَكَّنة. ويقال تعكَّن الشّيءُ تعكناً، إذا ارتكمَ بعضُه على بعض. قال الأعشى: إليها وإنْ فاته شُبْعَةٌ *** تأتّى لأخرَى عظيم العُكَنْ ومن الباب: النَّعَم العَكَنَانُ: الكثير المجتمع، ويقال عَكْنانٌ بسكون الكاف أيضاً. قال: * وصَبَّحَ الماءَ بوِردٍ عَكْنان * قال الدريديّ: ناقة عَكْناءُ، إذا غلُظَت ضَرَّتُها وأخلافُها. (عكو) العين والكاف والحرف المعتلّ أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على تجمُّع وغِلَظٍ أيضاً، وهو قريب من الذي قبله. [العَُكوَة ]: أصل الذَّنب. وعكَوْتَ ذَنَب الدّابَّة، إذا عطَفتَ الذَّنَب عند العَُكْوة وعقَدتَه. ويقال: عَكَتِ المرأةُ شعرها: ضفَرته. وربما قالوا عَكَا على قِرْنِه، مثل عَكَر وعَطَفَ. فإنْ كان صحيحاً فهو القياس. وجمع عَُكوة الذَّنَب عُكىً قال: * حَتَّى تُولِّيك عُكَى أذنابِها * ويقال للشَّاة التي ابيضَّ مؤخَّرها وسائرها أسود: عَكواء. وإنِّما قيل ذلك لأن البياض منها عند العَُكوة. فأمّا قولُ ابنِ مقبل: * لا يَعكُون بالأُزُرِ * فمعناه أنّهم أشرافٌ وثيابُهم ناعمة، فلا يظهر لمعاقد أُزُرِهم عكىً. وهذا صحيح لأنَّه إذا عَقَد ثوبَه فقد عكاه وجمّعه. ويقال: عَكَت النّاقةُ: غلظت. وناقةٌ مِعكاءٌ، أي غليظةٌ شَديدة. (عكب) العين والكاف والباء أصلٌ صحيح واحد، وليس ببعيدٍ من الباب الذي قبلَه، بل يدلُّ على تجمُّعٍ أيضاً. يقال: للإبل عُكوبٌ على الحوض، أي ازدحام. وقال الخليل: العَكَب: غِلظٌ في لَحْيِ الإنسان. وأمَةٌ عكباءُ: عِلْجَة جافية الخَلْق، من آمٍ عُكْبٍ. ويقال عَكَبت حولَهم الطّير، أي تجمَّعَتْ، فهي عُكُوبٌ. قال: تظلُّ نُسورٌ من شَمَامِ عليهما *** عُكُوباً مع العِقبان عقبانِ يَذْبُل ويقال العَكَب: عَوَج إبهام القدم، وذلك كالوَكَع. وهو من التضامِّ أيضاً. وقال قومٌ: رجلٌ أعكب، وهو الذي تدانت أصابع رجلهِ بعضِها من بعض. قال الخليل: العَكوب: الغُبار الذي تثِير الخيلُ. وبه سمِّي عُكَابة ابن صَعْب. قال بشر: نقَلناهُم نَقلَ الكلابِ جرَاءَها *** على كلِّ مَعلوبٍٍ يثور عَكُوبُها والغُبار عَكُوبٌ لتجمُّعه أيضاً. قال أبو زيد: العُكاب: الدُّخَان، وهو صحيح، وفي القياس الذي ذكرناه. ومن الباب: رجل عِكَبٌّ، أي قصيرٌ. وكلُّ قصيرٍ مجتمعُ الخلق. فأمّا قول الشيبانيّ: يقال: قد ثار عَكُوبُهُ، وهو الصَّخَب والقتال، فهذا إنما هو على معنى تشبيهِ ما ثار: الغبار الثائر والدُّخان. وأنشد: لَبينما نحنُ نرجو أن نصبِّحكم *** إذْ ثار منكم بنصف الليل عَكُّوبُ والتشديد الذي تراه لضرورة الشِّعر. (عكد) العين والكاف والدال أصلٌ صحيح واحدٌ يدلُّ على مثلِ ما دلَّ عليه الذي قبلَه. فالعكدة: أصل اللسان. ويقال اعتكَدَ الشيءَ، إذا لزِمَه. قال ابن الأعرابيّ: وهو مشتقٌّ من عَكَدة اللِّسان. فأمَّا قول القائل: سَيَصْلَى به القومُ الذين عُنُوا بها *** وإلاّ فمعكودٌ لنا أمُّ جندبِ فمعناه أنَّ ذلك ممكنٌ لنا مُعَدٌّ مُجمَع عليه. وأمّ جندب: الغَشْم والظُّلم. ويقال لأصل القلب عَكَدة. ومن الباب عَكَدَ الضبُّ عَكَداً، إذا سَمِنَ وغلُظ لحمه. قال: والعَكد بمنْزلة الكِدْنة، وهي السِّمَن. ويقال: إنّ العَكَد في النَّبات غلظهُ وكثرتُه. وشجرٌ عكِدٌ، أي يابس* بعضُه على بعض. وناقة عَكِدةٌ: متلاحِمَةٌ سِمَنا. ويقال: استعكد الضبُّ، إذا لاذَ بحَجَر أو جُحْر. قال الطِّرِمَّاح: إذا استعكدتْ منه بكلِّ كُدَايةٍ *** من الصَّخر وافاها لدى كلِّ مسرَحِ وعُكِد مثل حُبِس. والشيء المعَدّ معكود. (عكر) العين والكاف والراء أصلٌ صحيح واحد، يدلُّ على مثل ما دلَّ عليه الذي قبله من التجمُّع والتّراكُم. يقال اعتكر الليلُ، إذا اختلط سوادُه. قال: * تطاوَلَ اللَّيلُ علينا واعتَكَرْ * ويقال اعتَكَر المطرُ بالمكان، إذا اشتدَّ وكثُر. واعتكرت الرِّيح بالتُّرَاب، إذا جاءت به. ومن الباب العَكر: دُرْدِيُّ الزَّيت. يقال عَكِرَ الشَّرَاب يَعْكَر عكَراً. وعكَّرتُه أنا جعلت فيه عَكراً. ومن الباب عكر على قِرنِه، أي عطَفَ؛ لأنَّه إذا فعل فهو كالمتضامِّ إليه. قال: يازِمْلُ إنِّي إن تكن لي حادياً *** أعْكِر عليك وإن تَرُغْ لا نَسْبِقِ ويقال: ليس له مَعْكِر، أي مرجع ومَعطِف. ويقال: المَعكِر: أصل الشَّيء. وهو القياس الصحيح؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ يتَضامُّ إلى أصله. ورجع فلان إلى عِكْرِه، أي أصله. ويقولون: "عادت لعِكرِها لَمِيسُ". ومن الباب. العَكَر: القطيع الضَّخْم من الإبل فوق الخمسمائة. قال: * فيهِ الصَّوَاهلُ والراياتُ والعَكَرُ * ويقال للقِطعة عَكَرة، والجمع عَكَر، وربما زادوا في أعداد الحروف والمعنى واحدٌ، يقال: العَكَرْكَرُ: اللبن الغليظ. قال: فجاءَهُمْ باللَّبَنِ العَكَرْكَرِ***عِضٌّ لئيمُ المنتمَى والمَفْخَرِ وذكر ابن دريد: تعاكر القوم: اختلطوا في خصومةٍ أو نَحْوها. (عكز) العين والكاف والزاء أُصَيلٌ يقرُب من الباب قبله. قال الدريديّ: العَكْز: التقبُّض. يقال عَكِزَ يَعْكَزُ عَكْزاً. فأمَّا العُكَّازَة فأظنُّها عربيّة، ولعلَّها أن تكون سمِّيت بذلك لأنَّ الأصابع تتجمَّع عليها إذا قَبَضَت. وليس هذا ببعيد. (عكس) العين والكاف والسين أصلٌ صحيح واحدٌ، يدلُّ على مثل ما تقدَّم ذكره من التجمّع والجَمْع. قال الخليل: العَكيس من اللبن: الحليب تصَبُّ عليه الإهالة. قال: فلما سقيناها العَكِيس تَمَلأَّتْ *** مذاخِرُها وارفضَّ رَشْحاً وريدُها المذاخر: الأمعاء التي تذْخرُ الطَّعام. ومن الباب: العَكْس، قال الخليل: هو ردُّك آخرَ الشيءِ، على أوله، وهو كالعَطْف. ويقال تعكَّسَ في مِشْيَتِه. ويقال العَكس: عَقْل يدِ البعير والجمعُ بينهما وبين عنقه، فلا يقدرُ أن يرفعَ رأسه. ويقال: "مِن دون ذلك الأمر عِكاسٌ"، أي تَرادٌّ وتراجُع. (عكش) العين والكاف والشين أصلٌ صحيح يدلُّ على مِثل ما دلَّ عليه الذي تقدّمَ من التجمُّع. يقال عَكِشَ شعرُه إذا تلبَّد. وشعر مُتَعكِّش وقد تَعكَّش. قال دريد: تمنَّيْتَنِي قيسَ بنَ سعدٍ سفاهةً *** وأنت امرؤٌ لا تحتويك المَقَانبُ وأنت امرؤٌ جعد القفا متعكِّشٌ *** من الأَقِطِ الحَوليِّ شَبْعان كانبُ وأنشد ابنُ الأعرابيّ: إذ تَسْتَبِيك بفاحمٍ متعكّشٍ *** فُلَّتْ مَدَاريهِ أحَمُّ رَفَالُ وقد يقال ذلك في النبات. يقال: نباتٌ عكِشٌ، إذا التفَّ. وقد عَكِشَ عَكَشاً. والذي ذُكِر في الباب فهو راجعٌ إلى هذا كلّه. وفي كتاب الخليل أنّ هذا البناء مهمل. وقد يشِذُّ عن العالِم البابُ من الأبواب. والكلام أكثر من ذلك. (عكص) العين والكاف والصاد قريبٌ من الذي قبلَه، إلاّ أن فيه زيادةَ معنى، هي الشّدَّة. قال الفرّاء: رجل عَكِصٌ، أي شديد الخُلُق سيِّئُه. وعَكَصُ الرَّمل: شِدّة وُعوثتُه. يقال رملةٌ عَكِصَةٌ. (عكف) العين والكاف والفاء أصلٌ صحيح يدلُّ على مقابلةٍ وحبس، يقال: عَكَفَ يَعْكُفُ ويَعْكِفُ عُكوفاً، وذلك إقبالك على الشَّيء لا تنصرف عنه. قال: فهن يعكفن به إذا *حجا *** عَكْف النَّبيط يلعبون الفَنْزَجا ويقال عكفَت الطَّيرُ بالقتيل. قال عمرو: تركنا الخيلَ عاكفةً عليه *** مقلَّدةً أعنّتها صُفُونا والعاكف: المعتكف. ومن الباب قولهم للنَّظم إذا نُظم فيه الجوهر: عُكّف تعكيفاً. قال: وكأنَّ السُّمُوطَ عَكَّفَها السِّلْـ *** كُ بعِطْفَيْ جَيداءَ أمِّ غزالِ والمعكوف: المحبوس. قال ابن الأعرابيّ: يقال: ما عَكَفَكَ من كذا، أي ما حبَسك. قال الله تعالى: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أنْ يَبْلُغَ مَحِلَّه} [الفتح 25].
|